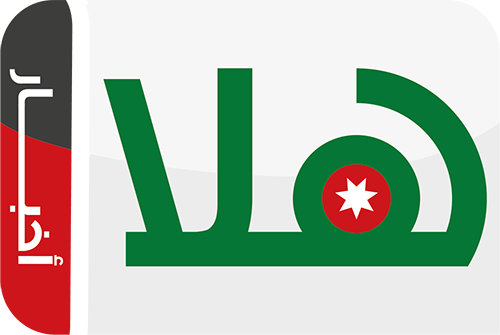تنبيهات صوتية على اشارات المرور للمكفوفين “تفاصيل”


-أحمد النعيمات
تدرس الحكومة من خلال مشروع قانون جديد، الزام كل من أمانة عمان ووزارة البلديات وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع مجلس الوزارء بتزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطرق المنتشرة بالمملكة لعبوره بأمان.
جاء ذلك بمسودة قانون حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2016، والذي حصلت “هلا اخبار” على نسخة منه.
وكما جاء بالمسودة فقد الزمت الحكومة الجهات المختصة بتدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، مثل الحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها.
وللتسهيل ايضا على المكفوفين وضعاف البصر بالشوارع العامة، الزم القانون الجهات المعنية بعدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر؛ وتطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.
واتاح القانون للجهات المعنية والمختصة فترة سماح لتطبيق كل ما سبق لنحو 5 سنوات من اقراره رسميا.
وفسر القانون الجديد جميع ما يتعلق بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة، وتوفير كل الدعم والتسهيلات من قبل جميع الجهات الرسمية:
وتاليا تفاصيل مسودة القانون:
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
– المجلس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– الرئيس: رئيس المجلس.
– الأمين العام: أمين عام المجلس.
– مجلس الأمناء: مجلس أمناء المجلس المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
– البطاقة: بطاقة الإعاقة التعريفية التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
– اللجنة: اللجنة الطبية الفنية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
– التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار، مباشراً كان أو غير مباشر، مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ويعد تمييزاً على أساس الإعاقة الامتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
– الموافقة الحرة المستنيرة: رضا الشخص ذي الإعاقة أو من ينيبه عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.
– الترتيبات التيسيرية المعقولة: تعديل الظروف البيئية أو الزمانية ضمن نطاق مكاني أو زماني محدد لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين، بما في ذلك توفير وسائط النقل المهيأة والمعينات والمعدات والأدوات والوسائل التقنية المساعدة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير المرافق الشخصي وتعديل طرق تدريس المناهج التعليمية ومواءمتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية دون الإخلال بجوهرها، والتعديل في مواعيد العمل أو تقديم الخدمة.
– الأشكال الميسرة: تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة الإشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
– إمكانية الوصول: تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني النافذ وأية معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس.
– التصميم الشامل: مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة.
– منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والأندية والاتحادات والشركات غير الربحية وغيرها من الجهات غير الحكومية المسجلة والمرخصة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة أغلبية أعضاء مجلس إدارتها ويتولى رئاسته أحدهم وتهدف إلى تعزيز الحقوق أو التمكين أو تيسير الوصول إلى الخدمات أو تنفيذ البرامج الخاصة بالإعاقة.
– المؤسسة التعليمية: المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم، وكذلك مراكز التربية الخاصة والجمعيات التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها.
المادة (3):
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال؛
ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال فترة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل؛
ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة؛
د- تشمل نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
- تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة؛
- الحركة والتنقل؛
- التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي؛
- التعلم والتأهيل والتدريب؛
- العمل؛
ه- تشمل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الحقوق والحريات المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
و- تحول الإعاقة دون ممارسة الشخص باستقلال لنشاطات الحياة الرئيسية وحقوقه وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (د) والفقرة (ه) من هذه المادة، إذا كانت ممارسته لأي منها تتطلب وجود أحد أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول أو المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4):
تشكل نصوص ومبادئ الدستور الأردني واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المرجعية الأساس في تفسير أحكام هذا القانون، ويجب مراعاة المبادئ الآتية في تطبيق أحكامه:
أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية؛
ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم؛
ج- عدم التمييز على أساس الإعاقة؛
د- قبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً من التنوع البشري والاختلاف الطبيعي؛
ه- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة؛
و- تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة؛
ز- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات؛
ح- تكافؤ الفرص؛
ط- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع؛
ي- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك من المتطلبات الضرورية لممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
المادة (5):
أ- لا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه أو حرياته أو تقييد تمتعه بها أو ممارسته لأي منها،كما لا يجوز تقييد حريته في اتخاذ قراراته على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- يعد فعلاً ضاراً يستوجب التعويض كل تمييز يرتكب على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ج- تعد القرارات الإدارية التي تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز مباشراً كان أو غير مباشر على أساس الإعاقة قرارات منعدمة؛
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة كافة الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر؛
ه- لا يجوز إجراء التجارب أو الأبحاث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .
و- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وذلك وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون؛
ز- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.
ح- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملاً للبطاقة؛
ط- لا يجوز إصدار البطاقة للأشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة الذين يتوقع زوال إعاقتهم خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ومع ذلك يظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز أن يستفيدوا من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.
المادة (6):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية نتيجة لعدم توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى .
ج- لا يجوز حرمان أو إعفاء الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها بالمخالفة للأسس والمعايير المطبقة على الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
المادة (7):
على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لكافة البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية، وتحقيق الحد الأقصى للتحصيل الأكاديمي لهم؛
ب- ضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم الإلزامي بالمؤسسات التعليمية، والعمل على منع إبعادهم عنها، وإخطار الجهات القضائية المختصة عن حالات الحرمان من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو تقييد الوصول إليها، وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون؛
ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك توفير أسئلة الامتحانات والإجابة عليها بلغة مبسطة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية، ومنح وقت إضافي في الامتحانات وأي تسهيلات أخرى؛
د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم بوصفهم تنوعاً بشرياً واختلافاً طبيعياً.
ه- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، على أن يبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطة خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمال تنفيذها فترة 7 سنوات؛
و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية؛
ز- توفير إمكانية الوصول في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية، والقيام بمواءمة القائم منها قبل نفاذ هذا القانون، والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، ولا يجوز منح ترخيص إقامة أي مؤسسة تعليمية خلافاً لأحكام هذه الفقرة.
المادة (8):
على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي وبرامج التدخل المبكر، ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب وتأهيل الكوادر عليها، من خلال فرق متعددة التخصصات تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة والأكاديميين والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وذوي الخبرة والاختصاص، في مجال التربية والتعليم وحقوق الإنسان وفقاً للضوابط الآتية:
أ- تحقيق الحد الأقصى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى أعلى مراحل التعليم؛
ب- توفير الحد الأقصى من البيئات التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة؛
ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى أقصى حد ممكن؛
د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي؛
ه- وضع آليات لتقييم تلك المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.
المادة (9):
أ- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، وعلى العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم؛
ب- تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية والإشراف عليها بما في ذلك تلك التي تتضمن برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة أياً كانت فئاتهم العمرية ، وعلى المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
المادة (10):
لا يجوز استبعاد الشخص من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها على أساس الإعاقة أو بسببها، وعلى وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بالتنسيق مع المجلس القيام، بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة التخصصات؛
ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الاعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (11):
أ- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي، وفقاً لما يتحمله الشخص ذي الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس.
ب- يكون الحد الأعلى من الرسوم الذي يتحمله الشخص ذي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (10%) للنظام التنافسي و(50%) للنظام الموازي؛
ج- إذا أثبتت مؤسسة التعليم العالي قيامها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة، فعلى المجلس التحقق من ذلك والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره منها أو الغائه في حال مطابقتها التامة للمعايير المعتمدة ذات الصلة.
المادة (12):
على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة؛
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وإلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص وتجديده؛
ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشائها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة؛
د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى عليهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية؛
ه- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وتصميم وتنفيذ برامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض؛
و- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها؛
ز- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن وصول المرأة ذات الإعاقة إلى برامج وخدمات الصحة الإنجابية، بما يحقق استفادتها الكاملة من تلك البرامج والخدمات؛
ح- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (13):
أ- تصدر وزارة الصحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية؛
ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة أجور المعالجة ولا أثمان الأدوية؛
ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية؛
د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على كافة أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:
- العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها؛
- الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية؛
- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي؛
هـ- يحدد وزير الصحة وفقاً لأحكام هذه المادة إجراءات منح بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وتجديدها وإصدار بدل التالف منها؛
و- يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.
المادة (14):
أ. لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها. ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الترشح لعمل أو وظيفة وشغلهما والاستمرار والترفيع فيهما؛
ب. لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالترشح لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة؛
ج. على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين؛
- تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها؛
- عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.
د. على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما؛
هـ. مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) عاملاً وموظفاً ولا يزيد عددهم عن (50)، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها ، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (50)، تخصص نسبة تصل الى 4% من شواغرها وفقاً لما تقرره وزارة العمل؛
و. تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون إلى وزارة العمل، على أن يتم تخصيصها لدعم برامج تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية؛
ز. على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل حول عدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.
المادة (15):
أ- تشكل لجنة تسمى لجنة تكافؤ الفرص برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
- ممثل عن وزارة العمل يسميه وزير العمل؛
- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية؛
- ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها؛
- ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها؛
- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن يسميه رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن؛
- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يسميهم الرئيس؛
- ثلاثة من أصحاب الخبرات المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهم الرئيس؛
- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
ب- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات الآتية:
- تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية؛
- إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل ومدى معقوليتها، بناءً على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية؛
- تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة بغرض تعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل؛
- التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية حول متطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل؛
- الاستعانة بالخبراء والمختصين حيثما كان ذلك لازماً؛
- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ج- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوى من رئيسها مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونيةً بحضور ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
د- يعين مجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته حال غيابه، وتكون مدة شغل هذا المنصب سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة؛
ه- يعين الأمين العام مقرراً للجنة تكافؤ الفرص يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.
و- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص، بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ومقررها ومن تستعين بهم من أهل الخبرة.
المادة (16):
على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين؛
ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛
ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع بها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (17):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون؛
ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة، لتحويل الجهات الحكومية وغير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات.
د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية جديدة بعد نفاذ هذا القانون.
ه- على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة ومراكز ومؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجةً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
المادة (18):
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (17) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
- تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل؛
- إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائجه؛
- توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفاء هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية؛
- تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها؛
- تمكين أسر وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.
ب- يشترط في من يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
- الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة العمل المناط به؛
- اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛
- الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك التبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية .
المادة (19)
على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها؛
ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها؛
ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك؛
د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها؛
ه- توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول إلى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف والتدخل المبكر عن الإعاقة؛
و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي والمهني في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها؛
ز- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون؛
ح- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والطبي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ط- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار في حالة وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والأهالي؛
ي- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.
المادة (20):
أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو المساس بتكامله الجسدي، أو إلحاق الأذى العقلي و/أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على كل من علم بوقوع عنف ضد شخص ذي إعاقة القيام بتبليغ الجهات المختصة.
ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والصحفيين وغيرهم، ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بإعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:
- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم؛
- السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم؛
- عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة؛
- توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة؛
- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
د- يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد حالات العنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية، والكشف عنها.
المادة (21):
على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، على أساس من المساواة مع الآخرين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو شهوداً، وفي كافة مراحل الدعوى؛
ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:
- مترجمو لغة إشارة متخصصون في ترجمة الإشارة القانونية؛
- خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛
- خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين.
ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين
د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم؛
ه- توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة (22):
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها؛
ب- على وزارة الأشغال بالتنسيق مع أمانة عمان والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:
- وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون، وتطبيق إمكانية الوصول عليها، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال سنة من تاريخ نفاذه، ولا يتجاوز إتمامها عشر سنوات؛
- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند السابق من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية؛
- إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها؛
- التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ القرار اللازم لتصويب الأوضاع وتنفيذ البدائل الدائمة والمؤقتة.
ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
- العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعة والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع؛
- اعتبارات الأمن والسلامة؛
- الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان؛
- أي ضوابط يضعها وزير الأشغال بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (23):
أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول؛
ب- على وزارة الأشغال وأمانة عمان والجهات ذات العلاقة إلزام الجهات التي تخالف إمكانية الوصول بعد نفاذ هذا القانون بتصويب أوضاعها، قبل منح إذن الأشغال. وتتخذ وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إزالة المباني أو أجزائها المخالفة والإغلاق المؤقت أو الدائم.
المادة (24):
على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب- تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول؛
ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارىء والكوارث الطبيعية؛
د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.
المادة (25):
على أمانة عمان ووزارة البلديات وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان؛
ب- وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية ونهاية الرصيف ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق؛
ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، مثل الحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها؛
ه- عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر؛
و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.
المادة (26):
على وزارة النق